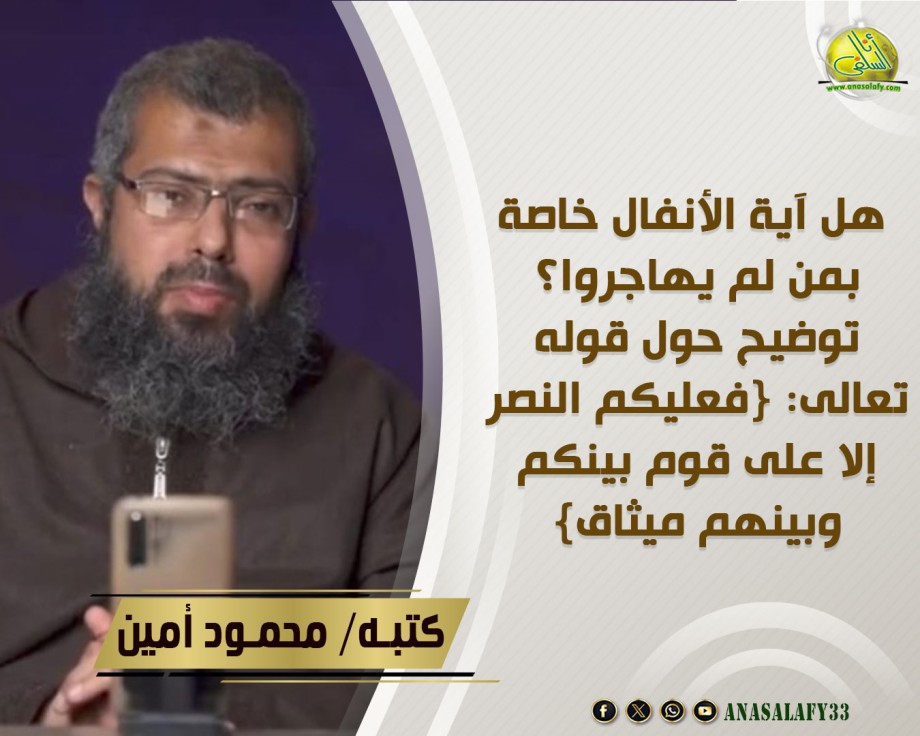هل آية الأنفال خاصة بمن لم يهاجروا؟ توضيح حول قوله تعالى: {فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق}
كتبه/ محمود أمين
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، أما بعد:
ففي مقطع فيديو قام بنشره الكاتب "فاضل سليمان" تناول فيه
الرد على فضيلة الشيخ "ياسر برهامي" في مسألة المعاهدات، وركز كلامه على
أن الاحتجاج بقوله تعالى {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم
وبينهم ميثاق} لا يصح ، معللا ذلك بأن الآية تتكلم عن مسلمين لم يهاجروا واستمروا
في بلاد الكفار بينما أهل غزة ليسوا كذلك لأنها ديار إسلام تم احتلالها، وأن تنزيل
الآية بهذا الشكل مجتزأ لأن قبلها جاء قوله تعالى {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على
قوم بينكم وبينهم ميثاق}.
وقد رأيت هذا الرد متداولا بنفس الاحتجاج من كتاب آخرين.
وهذه مناقشة وجواب علمي على ما ذكروه، نسأل الله أن يلهمنا جميعا
رشدنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل.
أولا: نسأل ما هو الوصف المؤثر والمناط الذي علق عليه الحكم بعدم وجوب
النصرة في الآية؟
الجواب:
أولا: الوصف المنصوص عليه هو قوله تعالى {إلا على قوم بينكم وبينهم
ميثاق} فهو وجود الميثاق.
وليس ترك الهجرة، أو أنهم في دار كفر، ولو كان ترك الهجرة هو الوصف
المؤثر لمنع من وجوب النصرة في الدين عموما، وليس فقط (على قوم بيننا وبينهم
ميثاق).
ولو كانت دار الكفر هي الوصف المؤثر لكان لا يجب النصرة سواء على قوم
بيننا وبينهم ميثاق أو لا.
وكل هذا لم تعلق الآية عليه الحكم فهي أوصاف طردية.
وإنما علق الحكم على الميثاق {إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق}.
بل كان ترك الهجرة مع القدرة معصية تنقص الولاية لكنها لا تمنع
النصرة.
ثم استثنى حالة وجود الميثاق، وهو ظاهر جدا في أن الهجرة لم تمنع ولا
كونهم وسط الكفار، بل أثبت لهم حكم النصرة ولكن الذي منع الميثاق.
فالآية عامة في كل قوم بيننا وبينهم ميثاق.
قال ابن كثير: وقوله: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على
قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير﴾ يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء
الأعراب الذين لم يهاجروا، في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛
لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ﴿بينكم وبينهم ميثاق﴾
أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا
مروي عن ابن عباس، رضي الله عنه.
ثانيا: من جهة القياس ما
الفارق بين مسلمين يقيمون وسط الكفار وبين بلد مسلم احتلها الكفار؟ فهذا مسلم وهذا
مسلم، وحق النصرة في الدين واجب لكل مسلم، ولو كان عاصيا أو مقصرا.
فليس هذا هو الذي يؤثر في الحكم.
ولكن لما كان الميثاق فيه رعاية مصلحة الطائفة المسلمة الكبيرة التي
عقدت الميثاق كان هذا مقدما على مصلحة الطائفة المؤمنة التي لم تهاجر وهي الأقل،
فيؤخر الدفع والنصرة إلى أن يجعل الله لهم فرجا.
وهذا موجود في كل من كان حاله مثل ذلك، لكل مسلمين لهم مصلحة أكبر في
الالتزام بالميثاق إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا الميثاق ويستطيعون الدفع عن جميع
المسلمين.
ثالثا: مكة في الأصل كانت دار إسلام لأن إبراهيم عليه السلام أسسها
على التوحيد ثم غلب عليها الكفار.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخرجوا منها وهي بلادهم التي
عاشوا فيها.
وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم "إنك لأحب بلاد الله إلى
الله ولولا أن قومك أخرجوني منها ما خرجت".
ومكة كان بها مؤمنون مستضعفون بل جاء الترغيب في القتال لنصرة لهؤلاء
المستضعفين في قوله تعالى: {ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا}.
والقرية الظالم أهلها باتفاق المفسرين هي مكة.
فمع الترغيب في القتال في سبيل الله نصرة للمستضعفين بمكة إلا أن هذا
لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من عقد صلح الحديبية، بل ومما جاء في شروطه رد
من جاء مسلما من أهل مكة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط برد أبي
جندل بن سهيل بن عمرو ورد أبي بصير.
رابعا: ومما يدل على أنه ليست العبرة بأنهم تركوا الهجرة أو أنهم
استمروا في بلاد الكفر؛ أن بعضهم كان مستضعفا عاجزا عن الهجرة ولما هاجر بعد
الحديبية هربا من قريش رده النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع من أبي بصير وأبي
جندل. فقد هاجروا بالفعل وأصبحوا خارج مكة، ومع ذلك التزم النبي صلى الله عليه
وسلم بالميثاق ولم يتغير الحكم بذلك، ولما جاءه أبو بصير وقال: "يا رسول الله
قد أوفى الله ذمتك رددتني إليهم فنجاني الله منهم". فقال ﷺ: "ويل أمه
مسعر حرب لو كان معه أحد". فأشار عليه بم يصنع ولم يعاونه بنفسه صلى الله
عليه وسلم من أجل الميثاق.
خامسا: هذا هو فهم أهل العلم لهذا الحكم. كما تكلم شيخ الإسلام
"ابن تيمية" عن نصارى ملطية وهي في الأصل بلد مسلم في سواحل الشام
احتلها النصارى، فأخبر أن العهد بين أهل المغرب وبين نصارى ملطية غير ملزم لمن لم
يدخل في الميثاق كأهل مصر والشام.
ونقله عنه "ابن مفلح" وقرره "ابن القيم" في فوائد
صلح الحديبية.
قال ابن القيم:
"ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام، فخرجت منهم طائفة
فحاربتهم وغنمت أموالهم، ولم يتحيزوا إلى الإمام = لم يجب على الإمام دفعهم عنهم
ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي
كان بين النبي ﷺ وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم.
وعلى هذا فإذا كان بين بعض
ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك
المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ
الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين" . انتهى.
فهذا هو فهم أهل العلم لهذه المسألة دون هذه التفرقة العجيبة التي
ذكروها.
سادسا: العهود والمواثيق مبناها على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة
فإذا كان المسلمون قادرون على الدفع عن غيرهم من المسلمين لزمهم نبذ العهود
والمواثيق والقيام بنصرتهم.
وأما عند عجزهم وضعفهم فينتظرون حتى يقوى جانبهم وتشتد شوكتهم
ويحافظون على الميثاق لأن فيه مصلحة لهم بتأجيل القتال الذي قد يفضي إلى استئصالهم
أو تسلط الأعداء عليهم.
ويلزمهم أثناء ذلك الأخذ بأسباب القوة والعمل على إزالة أسباب الضعف
التي حلت بهم.
سابعا: الجواب على احتجاج البعض بكلام ابن العربي في تفسير الآية وحكم
استنقاذ الأسرى:
احتج بعضهم بكلام ابن العربي في تفسير الآية، وعند الرجوع لكلام ابن
العربي في أحكام القرآن نجد أنه فسر الآية بنفس كلام أهل التفسير جميعا.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن":
(المسألة السابعة: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} [الأنفال:
72]: يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم، فأعينوهم؛ فذلك
عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا تقاتلوهم عليهم [يريد] حتى يتم
العهد أو ينبذ على سواء (2/439)
إلا أنه بعد ذلك استثني الأسرى فقال: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛
فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى
نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم،
حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك.
قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق
في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة
والعدد، والقوة والجلد). انتهى
وفي الحقيقة كلام ابن العربي هنا من وجوب استخلاص الأسرى لا يخالف ما
سبق لأنه شرط فيه القدرة والإمكان وهو الموافق لكلام أهل العلم جميعا من وجوب
استنقاذ الأسرى ولكن بشرط القدرة والإمكان.
ومما يدل على ذلك من كلام ابن العربي قوله هنا (بألا يبقى منا عين
تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع الأموال) فقيد
الأمر بوجود عدد يحتمل.
ولا يخفى أن كلام العلماء في فقه الجهاد على اعتبار الصفات مثل اعتبار
العدد بل هذا في زماننا هو القول الذي لا ينبغي أن يختلف فيه لأن كل الحروب والقوة
في زماننا مبناها على الصفات وليس فقط العدد.
- وابن العربي أيضا ذكر بذل الأموال وهو دون القتال (وهو الذي ذكره
ابن قدامة وذكر أن دفع الأموال في الهدنة وإن كان فيه صغار فهو لدفع صغار أعظم
وقاسها على استخلاص الأسرى).
- ويؤيد ذلك أيضا أن ابن العربي في آخر كلامه ذم أهل زمانه لتقاعدهم
عن استخلاص الأسرى مع القدرة قال (فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في
تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد
والقوة والجلد).
فتأمل أنه ذكر أن أهل زمانه لديهم العدة والعدد والقوة والجلد ، إذا
هو علق الأمر على القدرة ثم ذم القادر ، فكلامه لم يخالف فيه باقي العلماء عند
التحقيق، والله أعلم.
ثامنا: جميع أهل العلم الذين تكلموا عن وجوب استخلاص الأسرى
واستنقاذهم قيدوه بشرط القدرة والإمكان كما ذكره النووي في "روضة
الطالبين" والسرخسي الحنفي في "شرح السير الكبير". (وقد ذكر هذه
المسألة الشيخ ياسر برهامي في بحث فقه الجهاد وهو بحث نافع جدا فراجعه).
قال النووي في روضة الطالبين: لو أسروا مسلماً أو مسلمين فهل هو كدخول
دار الإسلام (يعنى في كون الجهاد يصبح فرض عين) وجهان أحدهما لا لأن إزعاج الجنود
لواحد بعيد ، وأصحهما نعم لأن حرمته أعظم من حرمة الدار فعلى هذا لابد من رعاية
النظر فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم
فعلنا وإن توغلوا فى بلاد الكفر ولايمكن التسارع إليهم وقد لايتأتى خرقها بالجنود
واضطررنا إلى الإنتظار كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام لا يتسارع
إليه آحاد الطوائف .
وقال السرخسي في شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن في مسألة استخلاص
الأسرى: فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر: فإن
كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين، فالواجب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم إذا كان
غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم، ما لم يدخلوا
حصونهم ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب، فكونها في أيديهم في دار
الحرب وفي دار الإسلام سواء. والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم، وذلك قائم
باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم.
فأما إذا دخلوا حصونهم فإن
أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به، *وإن تركوهم
رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك؛ لأن الظاهر أنهم بعد ما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا
حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل
النفوس والأموال في ذلك، فإن فعلوه فهو العزيمة، وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن
أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة. ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم والهند بعض
أسارى المسلمين، ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من
أيديهم. (شرح السير الكبير (ص: 207))
وقال أيضا: وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم
أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في الذراري، أو حتى يدخلوا
دار الحرب في الأموال، رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع؛ لأن البناء على
الظاهر جائز في مثل هذا. والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة.
وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه
إذا خرج أدركهم، وقوي على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا.
انتهى.
من كلام النووي والسرخسي نجد أنهم علقوا الأمر في استخلاصهم على غلبة
الظن والقدرة.
وجعل النووي هذه المسألة عند غلبة الظن أننا لا ندركهم مثل مسألة دخول
ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام فلا يتسارع إليه الآحاد.
كما ذكر السرخسي القيود الواضحة في كلامه (إذا كان غالب رأيهم أنهم
يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم)،
وقال: (والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم)،
وقال: (وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك لأن الظاهر أنهم بعد
ما وصلوا مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز السلمون عن استنقاذ الذراري ...)،
وقال: (رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع لأن البناء على الظاهر
جائز في مثل هذا والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة )،
وقوله بعدها: (وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغه إذا
كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم وقوي على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من
المسلمين).
فأين هذا من كلام البعض ممن ينادي بمسارعة الآحاد؟ ويقول بتعين الذهاب
لاستنقاذ المسلمين المستضعفين في غزة دون قدرة ودون استعداد ودون توقع حتى
بالاستخلاص؟ بل المتوقع هو عكس ذلك، فهل هذا إلا تحريف لكلام أهل العلم، واستعمال
إطلاقات دون قيودها الضرورية في كلامهم؟
فتبين لك بذلك اخي الكريم أنه لا اختلاف بين أهل العلم في فهم الآية،
ولا اختلاف بينهم في العمل بالعهود والمواثيق عند حاجة المسلمين لذلك، ولا خلاف
بينهم على اعتبار ضوابط القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة في الجهاد، ومنها مسألة
استخلاص الأسرى واستنقاذهم. والحمد لله رب العالمين.
موقع أنا السلفي